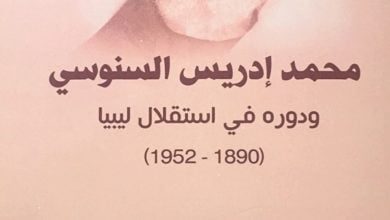حلقة مفاتيح
إلى أين أيّها البدويّ ؟!
مفتاح العمّاري
كنت أظن أن إبراهيم الكوني معلم كبير في صناعة السرد الروائي، أي من سلالة الكلاسيكيات المؤسسة، مثل دستويفسكي، وكازنتزاكيس، وتوماس مان. منذ احتفائي المبكر بقصته “إلى أين أيها البدوي”، ظل شغفي بقراءته، خارج شبهة المحرضات التي كرسته، منشغلا بمتنه، لا سيرته. وحتى بعد أن تورمت لغته إلى حد العجرفة؛ كنت أسوّغ هذه المثلبة، كاستجابة لغموض ميثولوجيا فضائه الصحراوي، كما لو أنه صائد حكمة، وصانع أسطورة، لا مجرد حكواتي؛ لكن القراءة المثابرة وحدها ستكشف عورة العجرفة، كمحض غلاف للغة هشة، حالما تفقد انسجامها لحظة اقترابها من بنيان المدينة، لا خيام الخرافة. وهذا ما حدث في ” أحلام الفرسان القتيلة”، بوصفها أول مقاربة سردية، تغامر بتنضيد أكثر اللحظات توترا في ربيع ليبيا الدامي. لهذا سأغضّ الطرف عن كل ألاعيب السرد هنا، لأن الحيز لا يسع سوى الإشارة والتلميح، لا التنظير والتفصيل. وبالمثل سأغفل التطرق لخلفية الرواية، كفضاء، استعار وقائع وأخبارا ومعلومات يُشك أحيانا في مدى صدقها وحقيقتها؛ لكن باعتبار الكوني ميالا بطبعه لتذويب جملة من الأفكار كرافد رئيس يدعم مشروعه السرديّ، عبر المجاورة بين الرواية والمنظور الفلسفي للعالم المتخيل. من ثم؛ ليس في وسعنا إهمال أحكامه التي تخللت ” أحلام الفرسان القتيلة”. نشير هنا تحديدا إلى الحيز المؤذي، الذي تضمنته الرواية حول جزء من سكان ليبيا، باعتبارهم – حسب وصفه – آفة بشرية ” من تلك الملة التي جاءت يوما من أعماق الأدغال برفقة تجار القوافل العابرة للصحراء. إنهم آخر دفعة من صفقة الرقّ …” وهي لكبوة فادحة؛ تسيء لمسيرة روائي كبير، كنّا نكن قدرا وافرا من الاحترام لتجربته، إلى حد أننا اعتبرناها فتحا جديدا في سرديات الصحراء.
كان من الأجدى للسارد العليم: عوض ازدراء عشيرة المدعو: ” بركة ” والتنكيل بتاريخ قومه ومعتقداتهم؛ الاكتفاء فقط بتلك المعالجة التي دفعته لإطلاق رصاصته الأخيرة؛ لتخترق نحر بركة، بوصفه مجرمًا، تقتضي الحكمة القصاص من شخصه هو، لا محاكمة عشيرته وجيناته الوراثية. لو اكتفى الكوني بهذا القصاص؛ لكان أكثر إنصافا، للحدث، وللرواية، ولتاريخه الشخصي.